مُعتَقَلُ المحبَسين: المعقول واللامعقول
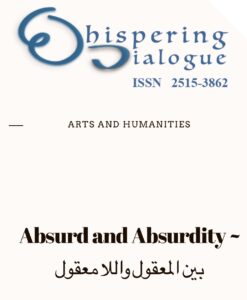


علي منير حرب
وصف علماء النفس والاجتماع الإنسان بأنه «حيوان عاقل».
وبين هذين المحبسين الإنسانية والحيوانية، العقل والغريزة، يقوم معتقل سرمدي يقبع فيه هذا المخلوق البشري، مكبّلًا بأصفاد المعقول واللامعقول، ما دام باحثًا – عاجزًا منذ ملايين السنين – عن العثور على حقيقة وجوده المطلقة، باستثناء الموت.
منذ البدء، كان صراع الإنسان محتدمًا بين ما يقبله عقله وإدراكه، وما يرفضه هذا العقل المجترِح للحلول، والمصنوع والمشكّل من طينة التجربة المنتجة للأعراف والتقاليد.
كانت الحقيقة، غير القابلة للتعديل أو الانحراف، ضالة هذا الإنسان، اللاهث عبثًا وراءها. وكلما صادفته المآزق والمخاوف، كان أكثر تشدّدًا في التنقيب عن الأسباب والمخارج، سواء عن طريق العقل، أم بواسطة العجائب والخوارق والقوى الغيبية الأخرى، الخارجة عن نطاق الطاقات المهيّأة له، من المرئيات والمدركات والأحاسيس جميعًا.
بين المعقول واللامعقول حكاية طويلة، رافقت البشرية، ضمن هذين المفهومين، اللذين يبدوان متعارضين، ولكنهما في الحقيقة متلازمان، ويمثلان الوجهين الطبيعيين المتقابلين للوجود.
كل ما هو متوافق مع المألوف كان معقولًا ومقبولًا ومطلوبًا للتمثّل والاقتداء. وكل ما هو مناف لمنظومة التوافقات الاجتماعية والعقيدية، مرفوض ومستهجن، يستوجب المعارضة أو الرفض، أو على الأقل الوقوف منه مواقف الشكّ والطعن.
انسحب مفهوم المعقول واللامعقول على مجمل نشاطات الإنسان وعلاقاته ومواقفه. وتداخل في أعمق أعماق مكوّناته الفكرية، ولم تنج الأديان والتعاليم من هذا الجدل والتداخل، ومنهما نشأت الفرق والطوائف والمذاهب، مختلفة أو متباعدة أو متناقضة، في تفسيراتها للحقيقة الضائعة.
وإذا كان نمط المعقول والمألوف والمقبول هو الذي ساد معظم رحلة الإنسانية في تاريخها، إلّا أن بذرة اللامعقول لم تغب أبدًا عن محطات هذه الرحلة، وإن تأخر مصطلحها اللغوي حتى بدايات القرن العشرين، وشاع في مجالات الأدب والفنون، قبل أن يغطي مجمل ميادين الشؤون السياسية والاجتماعية.
في التاريخ القديم والأوسط والحديث، لا نحتاج إلى كبير جهد للعثور على دلائل واسعة لهذه الظاهرة المتمثلة في اللجوء إلى عالم اللامعقول أو الغريب عن المعتاد، بهدف التوصل إلى تحقيق أغراض الإنسان ومآربه وتطلعاته نحو الخلود أو السيطرة أو السيادة. حتى بات من الثابت أن كمون اللامعقول، بمختلف هيئاته وقدراته، راسخ رسوخ المعقول فعلًا في غياهب النفوس، وليس بعيدًا عنه، ينتظر لحظة الاستدعاء ليتجلّى بإمكاناته المتوافقة مع مرامي الدعوة.
كان الإجماع مقرّا بحدوث الصراع بين العقل والهوى، وأن الإنسان ليس مسيّرًا بالعقل وحده – اللهم إلا باستثناء سقراط – وأن الناس صنفان: مَن يغلب عليه العقل فيكوّن إدراكه بالحكمة والبصيرة المستقاة من خزائن الجدود، ومَن يستسلم لرياح أخيلته، فتطير به ليسبح هائمًا في عوالم لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولا خطرت يومًا على بال بشر.
وقد يبدو للوهلة الأولى، أن الفرق بعيد بين هذين الصنفين: أحدهما يتتبع نور العقل وسبيله، والثاني يُطمئن نفسه بالأسطورة والخرافة، الأول يستنجد بقوانين العلم والمعرفة، والثاني يستعين بالخيال والأوهام. لكن الحقيقة المدهشة، هي أن هذين الصنفين هما واحد يتلبّس الوجهين تبعًا للظروف والغايات.
كان اليونان القدماء، كلما احتاجوا إلى تفسيرات أو وسائط تثبت حضورهم، يشقّون عباب السماء ويسبرون أغوار الأرض، ليتيحوا استنزال الآلهة من جميع الأصناف والمهام، أو استخراج الساحرات والمنجمّين، وتوظيفها، جيوشًا في الاحتياط، لمعاركهم وما يطمحون. فلا عجب أن تمتلئ حياتهم وعصورهم بالكائنات اللامعقولة قياسًا على طبائع مجتمعاتهم.
وكذلك فعل الرومان من بعدهم، وفعلت سائر شعوب الحضارات المتعاقبة، حتى أجدادنا العرب. وليس أدلّ على ذلك من انتشار أخبار العرّافين وقارئي النجوم وكاشفي الغيب للملوك والأمراء، ومدوِّني «سود الصحائف» من تخرّصات «السبعة الشهب»، ومن تلفيقات «الكوكب الغربي ذي الذنب»، على حدّ قول شاعرنا العربي «ابي تمّام»1 إشارة إلى قصيدة «فتح عمّورية» للشاعر ابي تمّام ومطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب. ، وما عمرت به مكتبات «بيت الحكمة» من خيالات «ألف ليلة وليلة»، ومستحيلات «الغول والعنقاء»، وجميعها تنبع من مصدر واحد، وهو إطلاق حبيس اللامعقول ليجترح الإنسان به مخرجًا، ويحقّق أعمالًا وإنجازات فوق ما يملك من كفاءات ومهارات.
قي القرن الثالث عشر وما بعده، سادت في جميع أوروبا، ظاهرة هبوط الساحرات والكائنات العجائبية في الأشكال والأفعال، وعليها بنى كبار الأدباء وكتاب المسرح عماراتهم الفنية، ومثالنا سيّد المسرح الإنجليزي «وليم شكسبير»، الذي استقى من هذا المنهل معظم مسرحياته، وحاك عليه أحداثه ونماذج شخصياته وأبطاله، مستعينًا بهذه القوى اللامعقولة ليتمّ عن طريقها الكشف عن طبيعة تحوّلات النفس البشرية وتنازعها بين الفضيلة والجريمة، وبين الوفاء والخيانة، وبين الخير والشر.
وعندما أطلق «اينشتاين»، قبل أكثر من قرن، نظريته الفيزيائية الثورية لـ«لنسبية»، كان منطلقه هو نسبية جميع الحركات، وأن كل جسم له ثلاثة أبعاد في الفضاء وأن الفضاء بُعد للزمن. ورأى أنه مادامت الحركة والتغيّر مستمرين فإننا نعيش في كون ذي أربعة أبعاد، والضوء هو الكمية الوحيدة غير المتغيرة في العالم كله.
بدت آراء «اينشتاين» في ذلك الوقت، غامضة على العلمانيين، واعتبروه أسطورة خرافية سفسطائية تهذي من علوّ أوليمبيّ بعيد. وقد لاحظ الفيلسوف البريطاني «برتراند راسل» هذه اللامعقولية التي تستعصي على مفهوم الناس فقال: «إن اينشتاين قد فعل شيئًا مدهشًا، بينما يعرف القليلون بالضبط ذلك الذي فعله.»
وتأسيسًا على مفهوم نظرية اللامعقول، فقد اشتعل النقاش في مستهلّ عصر النهضة العربية بين النقل والعقل، والثابت والمتحوّل، والأصيل والوافد، كما تم اعتبار تبنّي أفكار التغيير هرطقة وكسرًا للثوابت وخروجًا على المنهاج.
ونتيجة للثورة الزراعية والعلمية والصناعية وتطوّراتها التكنولوجية الحديثة، وجد الإنسان الحديث نفسه أمام زلزال وجودي فكري مدمّر، قلب باطن الأرض إلى ظهرها، وأنتج معطيات ووقائع وتقلّبات لم يسبق له أن اختبرها، ولم يجد لها مرجعًا معتادًا يلجأ إليه.
فما شهدته عوالم البشرية من خوارق وعجائب، في الابتكارات والسلوك والعلاقات، وما ارتكبه الإنسان من فواحش خارجة على صيغة «الحيوان العاقل»، حطّم منظومة العقل والمعقول، وأطاح بأسس المنطق ومربّعات أرسطو، وهدم كل ما بناه فلاسفة العقل على مدى الأزمان.
فما كان لامعقولًا ولا منطقيًا ولا مألوفًا قبل اليوم، تحوّل إلى واقع معقول ومشهود تتكرّر أحداثه وتتصاعد حدّ تفتيت الخيال والتوقّعات، وحدّ الترحّم على غرائب اللامعقول قديمًا. وما كان معقولًا ومقبولًا بات مثالًا ساطعًا للامعقول.
ووقف من سلم من تحت أنقاض هذا الزلزال متسائلًا: هل كانت آلهات الحروب والقتل لامعقولات، ومن اخترع الديناميت وآلات الدمار كان معقولًا؟ وهل من أهدى البشرية قنبلة الفناء الذرية كان حكيمًا ومعقولًا أكثر من لامعقولية الإله «زيوس» الذي حشا شرور العالم في الصندوق وسلّمه إلى «باندورا»2«صندوق باندورا» أسطورة يونانية، تروي كيف أن الإله «زيوس» أراد الانتقام من البشر ومن «بروميثيوس» الذي سرق شعلة النار، فخلق المرأة «باندورا» وحمّلها صندوقًا مليئًا بشرور البشرية، وأرسلها به إلى الأرض. انتقامًا لشعلة النار المسروقة؟
وهل كان المنطق سائدًا والعقل سائسًا والحكمة راعية، حين أبيدت شعوب بكاملها، واندثرت حضاراتها وثقافاتها، تحت معقولية «عقيدة الاكتشاف»3«عقيدة الاكتشاف» (The discovery doctrine)، «إعلان» بابوي، أصدره البابا «ألكسندر السادس» عام 1492 يسوّغ دينيًا عمليات القتل والنهب والإبادة التي مارستها أوروبا على الشعوب الأصلية عند اكتشاف في العالم الجديد.؟!…
وهل هو معقول ومألوف أن تبقى اللغة الإنسانية أداة مقبولة للتخاطب والحوار، بعد أن تبلبل منطق «الجبابرة» بآلاف الألسنة اللامفهومة، وأطلق المعايير والموازين المتناقضة اللامعقولة، التي حلّلت وحرّمت، وأباحت وحظّرت على هواها، من دون حساب لمنطق ولا عقل ولا حكمة؟
وأدّى هذا المأزق الوجودي المأساوي إلى إحداث صدمة عنيفة، خيّبت آمال المفكرين والأدباء والفنانين، وقادت إلى تغيير جذري في الأحكام والقواعد، كما ساهمت في انقلاب الذائقة الفنية، وتخلخل العلاقة بين المرسل والمتلقي، في مجالات العلوم والآداب والفنون، مما ولّد حركات واتجاهات جديدة تجسّدت بالمسرح الوجودي الذي حاول إظهار التناقض بين القيم والمبادئ من جهة، والواقع المرير من جهة أخرى، وسرعان ما اتخذ منحى متطورًا آخر، تمثل بمسرح العبث واللامعقول، الذي أطلق هذا المصطلح اللغوي الجديد، تعبيرًا عن عزلة قاتلة وانفصال كامل عن اللحظة المعيشة، وعن عبثية الوجود وخوائه وانقلاب المفاهيم والعادات والطبائع غير المبرّرة، التي أدّت إلى استحالة التفاهم الإنساني بسبب قصور اللغة عن أداء مهمتها في التواصل. وتجسّد كل ذلك في كتابات «يوجين يونيسكو» و«صموئيل بيكيت»، و«جان جينيه» و«فرانز كافكا» وغيرهم، من الذين ركزوا في موضوعاتهم على ثيمة القلق، وطرح التساؤلات الميتافيزيقية عن الإنسان والزمن والحياة والموت، وثاروا على الأسس الثقافية لعالم الحروب وأطماع السيطرة، والمجد القائم على الأكاذيب الساحقة لجوهر الروح والعقل، والهادفة إلى محو الشخصية الإنسانية.
إن الإدراكات المباشرة التي تعانيها البشرية، منذ مطلع القرن العشرين، تشير كلها إلى جموح نزعة اللاعقل، وأن تراث الفكر الإنساني مشبع بالنقيضين المعقول واللامعقول.
فهل نكون مغالين إذا ما سخرنا اليوم من المقولة «المعقولة السابقة» التي صنّفت الإنسان بأنه «حيوان عاقل وناطق»؟ وهل نبتعد عن صوت العقل والمنطق حين ننعى للإنسانية موت العقل ليسود اللامعقول في عالم مخيف لامفهوم.
وهل ترانا نجانب الحقيقة، إذا ما اعترفنا بأن اللامعقول طبيعة والمعقول استثناء، فيما نشهد أسر الإنسانية – ضحية البربرية الحديثة – في معتقلات جنون اللامعقول؟!..
الهوامش:
- إشارة إلى قصيدة «فتح عمّورية» للشاعر ابي تمّام ومطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب.
- «صندوق باندورا» أسطورة يونانية، تروي كيف أن الإله «زيوس» أراد الانتقام من البشر ومن «بروميثيوس» الذي سرق شعلة النار، فخلق المرأة «باندورا» وحمّلها صندوقًا مليئًا بشرور البشرية، وأرسلها به إلى الأرض.
- «عقيدة الاكتشاف» (The discovery doctrine)، «إعلان» بابوي، أصدره البابا «ألكسندر السادس» عام 1492 يسوّغ دينيًا عمليات القتل والنهب والإبادة التي مارستها أوروبا على الشعوب الأصلية عند اكتشاف العالم الجديد.