زحفًا زحفًا نحو الفشل!...
زعماء الهاوية وحرّاس المغارة
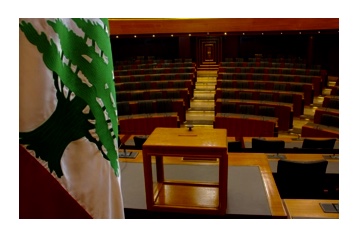
بقلم: د. علي حرب
جريدة “الأخبار-النهار”
مونتريال / كندا
العدد 944
24/04/2018
يستهبلني إلى حدّ التقزّم، عدد من الشعارات والعبارات الزائفة والمضلّلة، التي يطلقها السياسيون اللبنانيون، المعارضون والموالون، وغير السياسيين على السواء، والتي تراوغ وتحايل لتعطّل عقل اللبناني وإرادته.
من هذه الشعارات، والتي يزايد فيها رجال السياسة على بعضهم، ويضحكون فيها على ذقون الناس، ويستخفّون بعقولهم، أتوقّف في هذا المقال، عند أحدها، والذي يعتبر الأكثر زيفًا وخداعًا، وهو الذي يصف حال الدولة اللبنانية فيقول: “في لبنان دويلات داخل الدولة تعطّل دورها وتشلّ فعاليتها”.
هذا الشعار يطمس الحقيقة الجارحة التي يعيها ويعيشها المواطن اللبناني، وهي أنه، وكما بات متجذرًا في أذهان الجميع، لا دولة أساسية في لبنان، بل ثمّة دول داخلية فئوية إحتلت الوطن وقبضت على سلطات الدولة وقراراتها وتحكّمت بمفاصل مؤسساتها، كما استولت على ثروات الوطن ومقدّراته، حتى أصبح التساؤل سائدًا على كل لسان، وعند كل أزمة: “أين هي الدولة”؟
في لبنان لا دولة تحكم، ولا دولة تتولى شؤون البلاد والعباد.
في لبنان سلطات طوائفية ومذاهبية، تتحكّم وتحكم، كل من وجهة نظرها، وبما يخدم أتباعها وتحالفاتها، تحت مسمّى الأحزاب الوطنية اللبنانية، حيث أصبح كل مجتمع سياسي في لبنان عبارة عن دولة مستقلة بذاتها، تتنافس في ما بينها، مذهبيًا وطائفيًا، من أجل تحصيل المكاسب لزعمائها وأتباعها. ولا أزال أتساءل هل تختلف حقوق المواطن المسيحي الماروني والكاثوليكي والأرثوذكسي، عن حقوق شريكه في المواطنية، المسلم الشيعي والسني والدرزي؟!…
تغييب الدولة في لبنان، ومنذ قرون عديدة، أتاح لزعماء الملل أن يملؤوا الفراغ الكبير حفاظًا على وجودهم ومراكزهم ومكتسباتهم.
“الدولة اللبنانية” المفترضة، لم يعد لها وجود قائم لا مادي ولا معنوي، بسبب فشلها منذ أمد بعيد، في أن تنال شرف مسمّى الدولة الحقيقية، كما هو وارد في التعريفات السياسية والفلسفية، عبر التاريخين القديم والحديث.
بحثت ونقبّت طويلًا في تاريخ الدول والشعوب، فلم أعثر على دولة كلبنان تُرضي طوائفها، في المحاصصات والمراكز والمؤسسات والدوائر والموظفين، على حساب الوطن، وتوزّع خيراته وخزينته وموازناته هبات طائلة على أزلامها، ثم يتصارخ زعماؤها منادين بالتقشّف وشدّ الأحزمة ومكافحة الفساد والهدر، مطالبين أبناء الوطن “بتقدير الظروف الاقتصادية” وفتح جيوبهم لمنح ما تبقى فيها لحرّاس المغارة ونهّابها…
لم أعثر على دولة على خارطة الكرة الأرضية، تقامر بأموال شعبها وحقوقه، وتدفعه دفعًا وقهرًا للهجرة والاغتراب بحثًا عن وطن بديل، وما أن تشعر هذه الدولة بجفاف ينابيع الثروات التي نهبها حرّاسها، حتى يتراكض منظّروها “الخارقين” خلف أبنائها الهاربين من جحيمها، لتناشدهم، بكل وقاحة وصفاقة وعهر، بضخّ عرق جبينهم في الخزينة الفارغة، وضخّ أصواتهم في صناديق الاقتراع ضمانًا لاستمرارهم على كراسي النهب والسرقات، وكلّ ذلك تحت الشعار المزيّف والمسموم بالحفاظ على الحقوق الوطنية للمنتشرين.
من التعريفات البسيطة للدولة أنها “عبارة عن تنظيمٍ سياسي يكفل حماية القوانين وتأمين النظام لمجموعة من الناس يعيشون على أرض معيّنة بشكل دائم، ويجمعهم عدد من الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية المشتركة.”
و”يقترن اسم الدولة بعدد من الأجهزة المكلّفة بتدبير شأن المجتمع العام، وتحقيق الحرية والأمن والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد.”
ويرى جون لوك “أنّ الدولة تستمد مشروعيتها عن طريق ما تحقّقه من خيرات ناتجة عن توفير حقوق مدنيّة للأفراد، فلا يمكن لأية دولة أن تحظى بالمشروعية إلا إذا كانت لديها القدرة على توفير الأمن وتمكين الأفراد من ممارسة حريتهم، وحماية ممتلكاتهم، وتكريس قيم المساواة بين أفراد المجتمع.”
ويؤكد أرسطو “أن الإنسان وُجد كي يعيشَ في دولة ولقد وُجدت الدولة من أجل تحقيق الخير لهم.”
لن أعلّق على هذه التعريفات البسيطة، بل أترك للقارئ البحث، إذا استطاع، عن وجود الدولة اللبنانية بين ثنايا هذه التعريفات الفلسفية والسياسية!
ولكي لا يدرج كلامنا في دائرة التجنّي أو الظنّ الخبيث، أو ضمن إطار تكسير مجاديف السفينة، لنراجع معًا مؤشرات ومعايير التصنيف الدولي للدول المستقرّة أوالهشّة أو الفاشلة، كما ورد في التقارير السنوية الصادرة عن صندوق السلام ومجلة فورين بوليسي في الولايات المتحدة الأميركية، ولنحاول الإجابة على الأسئلة التالية، كي نتمكن من تحديد موقع الدولة اللبنانية في هذا التصنيف:
أولاً: في المؤشرات الاجتماعية
ماذا عن العناية الصحية والطبية؟
ماذا عن ضمان الشيخوخة؟
ماذا عن التعليم الرسمي والخاص؟ وماذا عن الجامعة اللبنانية الوطنية؟
ماذا عن الهدر والفساد والرشاوى وانتشار المعاملات العرفية؟
ماذا عن البنى التحتية؟
ماذا عن الأمن والأمان؟
ماذا عن المياه والكهرباء والنفايات والتلوّث القاتل في الهواء والأنهار والبحر والمزروعات ومياه الشفة؟
ماذا عن النزيف المستمر في تهجير المواطنين وانتشار ظاهرة هروب العقول والطاقات والكفاءات؟
ماذا عن توقف الأوتستراد العربي الذي بوشر به عام 2009؟ ولماذا انقطع أوتستراد الجنوب في منطقة الأوزاعي؟
ماذا عن الأملاك البحرية المغتصبة؟
ماذا عن السلاح المتفلّت بين أيدي الناس؟
ماذا عن الدماء المسفوحة يوميًا على الطرقات؟
ثانيًا: في المؤشرات الاقتصادية
ماذا عن التنمية الاقتصادية المتوازنة؟
ماذا عن التدهور الإقتصادي الذي لامس مرحلة الإنهيار كما يعترف الرؤساء والوزراء أنفسهم؟
ماذا عن الخطط الاقتصادية المستقبلية للنهوض في القطاعات كافة؟
ماذا عن الديون المترتبة على الدولة اللبنانية؟
ثالثًا: المؤشرات السياسية
ماذا عن الحريات المدنية والحقوق؟
ماذا عن التدخلات الخارجية؟
ماذا عن موضوع النازحين؟
ماذا عن صعود النخب المنقسمة؟
ماذا عن تدخلات الدول الأجنبية؟
ماذا عن المحافظة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضي الدولة، دون السماح لجماعات مسلحة أو أمراء الحرب أو أي تنظيم مسلّح من السيطرة على أي جزء داخل الأراضي، بحيث أن تبقى الكلمة الفصل والسلطة للدولة وحدها؟
ماذا عن تنامي حالة ازدواجية المسؤولية الأمنية؟
ماذا عن تعطيل الحياة السياسية في انتخابات رؤساء الجمهورية أو تشكيل الحكومات؟
ماذا عن سياسة النأي بالنفس؟
وللعلم فقط، فإن ما ورد ليست أسئلة للمعايير المدرجة لتصنيف الدول فحسب، إنما هي ملفات وأزمات شائكة ومتضخّمة في لبنان، تنتقل، ومنذ عشرات السنين، من حكومة إلى أخرى، ومن لجنة إلى لجنة، ومن فضيحة إلى فضيحة.
لا أريد أن أجيب عن الواقع الذي يعانيه لبنان في كل جانب من جوانب المعايير والمؤشرات السابقة، ولكن أحيل الأسئلة إلى تصريحات المسؤولين أنفسهم، الذين تعاقبوا على ملء الكراسي الحكومية والنيابية، منذ 1975 وحتى الآن، أي على مدى يقارب نصف قرن، أجل نحو خمسين سنة من عمر لبنان وأجيال لبنان ومستقبل لبنان، هذا إذا لم نبتعد أكثر وأكثر في التاريخ.
أحيل الأسئلة إلى هؤلاء المسؤولين ليجيبوا بأنفسهم، ويقنعوا الناس بأننا لا نتسابق الخطى ونزحف زحفًا نحو الفشل.
الأسئلة كثيرة ومصيرية وحادّة، ويبقى السؤال الوطني الأكبر لزعماء الهاوية كافة: ألا يستحق لبنان الذي أجاد عليكم بكل هذه السلطات والثروات، ألا يستحق هذا المريض الوطني المذبوح والنازف، وقفة تاريخية فاحصة وناقدة بصدق وعدل ونزاهة؟
ألا يستحق هذا الوطن المعذّب نخبة من الشرفاء والحكماء ونظيفي الكفّ والضمير، من أصحاب الخبرات والكفاءات، لإعلان حالة طوارئ وطنية؟
لا أنكر أبدًا، أن العالم، ما زال يعترف بوجود “الدولة اللبنانية” كسلطة سياسية، ولا علاقة هنا بموضوع الكيان الوطني الجغرافي والسياسي.
ولا أنكر أيضًا أن لبنان لم يصنّف حتى الآن في قائمة الدول الفاشلة، وأشكر الله الحامي للبنان، بأنه لم ينزلق إلى هاوية الصوملة أو السودنة أو اليمننة، لكن أشدّ ما أخشاه، هو ذلك الخط المتّجه هبوطًا، عامًا بعد عام، نحو تصنيفنا ضمن الدول الهشّة أو الفاشلة في العالم.
حتى الآن، جاء في التقرير المشار إليه آنفًا، أن لبنان مصنّف ضمن قائمة الدول “ذات تحذير عال جدًا”.
فإلى متى يا ترى ستبقى الدول الصديقة والمانحة محافظة على ثقتها بلبنان ومستعدة للاستجابة لمطالبه وحاجاته في مؤتمرات الدعم الدولي لهذا البلد؟
وإلى متى سيبقى المواطن اللبناني غائبًا في وطنه عن وطنه ومهجّرًا لاجئًا للاحتماء بطائفته؟!…